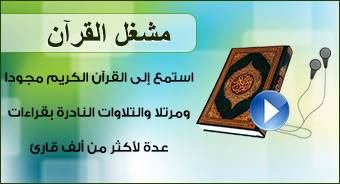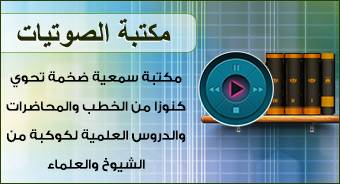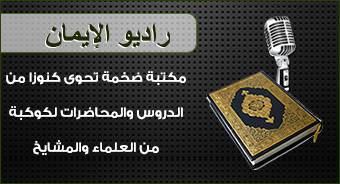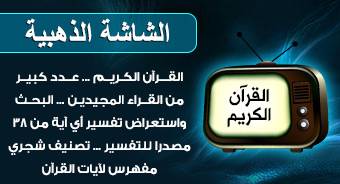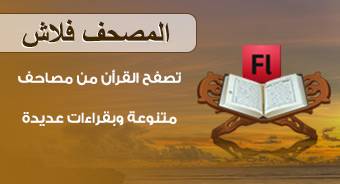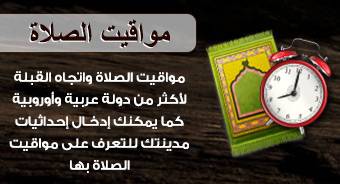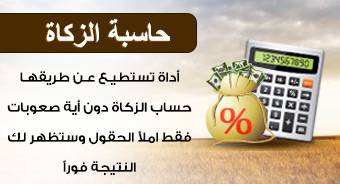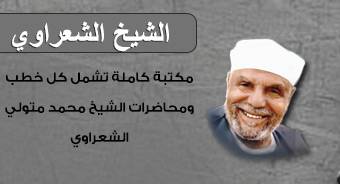|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا (نسخة منقحة)
ثم ارتجعهما بنو يعفر منه ورجع هو إلى صعدة، فتوفي بها سنة ثمان وتسعين ومائتين، لعشر سنين من بيعته. قال ابن المحاب: وله مصنفات في الحلال والحرام. وقال غيره، كان مجتهداً في الأحكام الشرعية، وله في الفقه آراءٌ غريبة، وتآليف بين الشيعة مشهورة، قال ابن حزم: ولم يبعد في الفقه عن الجماعة كل البعد.قال الصولي: ثم ولي بعده ابنه محمد المرتضى وتمت له البيعة، فاضطرب الناس عليه. قال في أنساب الطالبيين: واضطر إلى تجريد السيف فجرده. وفي ذلك يقول: [رمل] ومات سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة لثنتين وعشرين سنةً من ولايته.وولي بعده أخوه الناصر فاستقام ملكه.ثم ولي بعده ابنه الحسين المنتجب بالجيم ومات سنة أربع وعشرين وثلثمائة.وولي بعده أخوه القاسم المختار بعهدٍ من أخيه المذكور، وقتله أبو القاسم بن الضحاك الهمداني سنة أربع وأربعين وثلثمائة.وولي بعده صعدة جعفر الرشيد ثم بعده أخوه المختار ثم أخوه الحسن المنتجب ثم أخوه محمد المهدي.قال ابن المحاب: ولم تزل إمامتهم بصعدة مطردةً إلى أن وقع الخلاف بينهم وجاء السليمانيون أمراء مكة حين غلبة الهواشم عليهم فغلبوا على صعدة في المائة السادسة.قال ابن السعيد: وقام بها منهم أحمد بن حمزة بن سليمان، بن داود، ابن عبد الله، بن المثنى، بن الحسن السبط، وغلب على زبيد وملكها من بني مهدي، ثم انتزعها بنو مهدي منه، وعاد إلى صعدة ومات.فولي بعده ابنه المنصور عبد الله بن أحمد بن حمزة، وامتدت يده مع الناصر لدين الله خليفة بني العباس ببغداد، وبعث دعاته إلى الديلم والجبل، فخطب له بهما وأقيم له بهما ولاة، وكان بينه وبين سيف الإسلام بن أيوب، ثم الملك مسعود ابن الملك الكامل حروب باليمن. وبقي حتى توفي سنة ثلاثين وستمائة عن عمرٍ طويل.وولي بعده ابنه أحمد بن المنصور عبد الله بن أحمد بن حمزة، ولقب بالمتوكل صغيراً ولم يخطب له بالأمامة لصغر سنه.وكان بنو الرسي حين غلب عليهم السليمانيون بصعدة أووا إلى جبلٍ شرقي صعدة، فلم يبرحوا عنه، والخبر شائع بأن الأمر يرجع إليهم، إلى أن كان المتوكل أحمد بن السليمانيين، فبايع الزيدية أحمد الموطىء، بن الحسين المنتجب، بن أحمد الناصر، بن يحيى الهادي، بن الحسين، بن القاسم الرسي، بن إبراهيم طباطبا، المقدم ذكره في سنة خمس وأربعين وستمائة.وكان الموطىء فقيهاً أديباً عالماً بمذهبهم، قواماً صواماً، فأهم عمر بن علي بن رسول صاحب زبيد شأنه، فحاصره بحصن ملا سنةً فلم يصل إليه، وتمكن أمر الموطىء وملك عشرين حصناً، وزحف إلى صعدة فغلب السليمانيين عليها، فنزل أحمد المتوكل: إمام السليمانيين إليه، وبايعه في سنة تسع وأربعين وستمائة، وحج سنة خمسين وستمائة وبقي أمر الزيدية بصعدة في عقبه.وقد ذكر المقر الشهابي بن فضل الله في مسالك الأبصار: أنه سأل تاجج الدين عبد الباقي اليماني أحد كتاب اليمن عن تفاصيل أحوال هذه الأئمة فقال: إن أئمة الزيديين كثيرون، والمشهور منهم المؤيد بالله، والمنصور بالله، والمهدي بالله، والمطهر يحيى بن حمزة. قال: ويحيى بن حمزة هو الذي كان آخراً على عهد الملك المؤيد داود بن يوسف صاحب اليمن، وكانت الهدنة تكون بينهما.وذكر في التعريف أن الأمامة في زمانه كانت في بني المطهر. ثم قال: واسم الأمام القائم في وقتنا حمزة. ثم قال: ويكون بينه وبين الملك الرسولي باليمن مهادنات ومفاسخات تارةً وتارةً. قال قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون في تاريخه: وقد سمعت بمصر أن الأمام بصعدة كان قبل الثمانين والبسعمائة علي ابن محمد من أعقابهم، وتوفي قبل الثمانين، وولي ابنه صلاح، وبايعه الزيدية، وكان بعضهم يقول فيه: إنه ليس بإمامٍ لعدم اجتماع شروط الأمامة، فيقول: أنا لكم على ما شئتم: إمامٌ أو سلطان.ثم مات صلاحٌ آخر سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، وقام بعده ابنه نجاح وامتنع الزيدية من بيعته. فقال: أنا محتسب لله تعالى.قلت: وقد وهم في التعريف: فجعل هذه الأئمة من بقايا الحسنيين القائمين بآمل الشط من بلاد طبرستان، وأن القائم منهم بآمل الشط بطبرستان هو الداعي المعروف بالعلوي من الزيدية، وهو الحسن، بن زيد، بن محمد، بن إسماعيل، بن الحسن السبط، بن علي، بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج سنة خمس وخمسين ومائتين أو ما يقاربها، فملك طبرستان وجرجان وسائر أعمالها ثم مات، وقام أخوه محمد بن زيد مقامه. وكان لشيعته من اليزيدية دولةٌ هناك، ثم انقرضت وورثها الناصر الأطروش وهو الحسن بن علي، بن الحسين، بن علي، بن عمر، بن علي بن زين العابدين، بن الحسين السبط، بن علي، بن أبي طالب، وكان له دولة هناك.ثم خرج على الأطروش من الزيدية الداعي الأصغر، وهو الحسن بن القاسم، بن علي، بن عبد الرحمن، بن القاسم، بن محمد البطحائي، بن القاسم، بن الحسن، بن زيد، بن الحسن السبط، وجرى بينه وبلين الأطروش حروبٌ إلى أن قتل سنة تسع عشرة وثلثمائة، ويجتمع الداعي الأصغر مع الداعي الأكبر في الحسن بن زيد، وليس بنو الرسي الذين منهم أئمة اليمن من هؤلاء بوجهٍ.الجملة الثالثة في ترتيب مملكة هذا الأمام:قال في التعريف بعد أن ذكر إمام زمانه: وهذا الأمام وكل من كان قبله على طريقة ما عدوها، وهي إمارة أعرابية، لا كبر في صدورها، ولا شمم في عرانينها، وهم على مسكة من التقوى، وترد بشعار الزهد، يجلس في ندي قومه كواحدٍ منهم، ويتحدث فيهم ويحكم بينهم، سواءٌ عند المشروف والشريف، والقوي والضعيف. قال: وربما اشترى سلعته بيده، ومشى بها في أسواق بلده، لا يغلط الحجاب، ولا يكل الأمور إلى الوزراء والحجاب، يأخذ من بيت المال قدر بلغته من غير توسع، ولا تكثر غير مشبع هكذا هو وكل من سلف قبله، مع عدلٍ شامل، وفضلٍ كامل.وذكر في مسالك الأبصار عن تاج الدين عبد الباقي اليماني الكاتب نحو ذلك. فقال: وأئمتهم لا يحجبون ولا يحتجبون، ولا يرون التفخيم والتعظيم، الأمام كواحد من شيعته: في مأكله ومشربه وملبسه، وقيامه وقعوده، وركوبه ونزوله، وعامة أموره، يجلس ويجالس، ويعود المرضى، ويصلي بالناس على الجنائز، ويشيع الموتى ويحضر دفن بعضهم. قال: ولشيعته فيه حسن اعتقاد، ويستشفون بدعائه، ويمرون يده على مرضاهم، ويستسقون المطر به إذا أجدبوا، ويبالغون في ذلك مبالغة عظيمةً، قال المقر الشهابي بن فضل الله: ولا يكبر لإمامٍ هذه سيرته في التواضع لله وحسن المعاملة لخلقه، وهو من ذلك الأصل الطاهر، والعنصر الطيب أن يجاب دعاؤه، ويتقبل منه. وينادي ببلاد هذا الأمام في الأذان بحي على خير العمل بدل الحيعلتين، كما كان ينادى بذلك في تأذين أهل مصر في دولة الخلفاء الفاطميين لها. قال في التعريف: وأمراء مكة تسر طاعته، ولا تفارق جماعته. قال ابن غانم: هذا الأمام يعتقد في نفسه ويعتقد في أشياعه فيه أنه إمامٌ معصوم، مفترض الطاعة، تنعقد به عندهم الجمهعة والجماعة، ويرون أن ملوك الأرض. وسلاطين الأقطار يلزمهم طاعته ومبايعته، حتى خلفاء بني العباس، وأن جميع من مات منهم مات عاصياً بترك مبايعته ومتابعته. قال: وهم يزعمون ويزعم لهم أن سيكون لهم دولة يدال بها بين الأمم، وتملك منتهى الهمم، وأن الأمام الحجة المنتظر في آخر الزمان منهم.وذكر عن رسول الله هذا الأمام، الواصل إلى مصر: أن الأئمة في هذا البيت أهل علم يتوارثونه: إمامٌ عن إمام، وقائمٌ عن قائم. وذكر عن بعض من مر بهم أنه فارقهم في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وهم لا يشكون أنه قد آن أوان ظهورهم، وحان حين ملكهم، ولهم رعايا تختلف إلى البلاد، وتجتمع بمن هو على رأيهم، تصون ضعف الدولة في أقطار الأرض.وحكى المقر الشهابي بن فضل الله عن قاضي القضاة كمال الدين محمد ابن الزملكاني قاضي حلب: أنه مات رجلٌ من شيعتهم بحلب، فوجد عنده صندوقان، ضمنهما كتبٌ من أئمة هذه البلاد إلى ذلك الرجل وإلى سلفه، يستعرفون فيها الأخبار، وأحوال الشيعة، والسؤال عن أناس منهم، وأن في بعضها: ولا يؤخر مدد من هنا من إخوانكم المؤمنين في هذه البلاد الشاسعة، وهو حق الله في تزكية أموالكم، ومدد إخوانكم من الضعفاء واتقوا الله و{استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً}.ونقل عن الشيخ شهاب الدين بن غانم: أنه حدثه عند وصوله من اليمن أن هذا الأمام في منعةٍ منيعة، ودروة رفيعة، وأنه يركب في نحو ثلاثة الأف فارس، وأن عسكره من الرحالة، خلق لا جسم، وذكر عمن أقام عندهم: أنهم أهل نجدة وبأس، وشجاعة ورأي، غير أن عددهم قليل وسلاحهم ليس بكثير، لضيق أيديهم، وقلة بلادهم، ونقل عن تاج الدين عبد الباقي اليمني: أنه قومه معه على الطواعية والأنقياد، لا يخرج أحدٌ منهم له عن نص، ولا يشاركه فيما يتميز به.قال ابن غانم: وزي هذا الأمام وأتباعه زي العرب في لباسهم والعمامة والحنك، بخلاف ما تقدم من زي صاحب اليمن من بني رسول، قال الشيخ شهاب الدين بن غانم: وهذا الأمام لا يزال صاحب اليمن يرعى جانبه، وفي كل وقت تعقد بينهما العقود، وتكتب الهدن، وتوثق المواثيق، وتشترط الشروط.قال في التعريف: وقد وصل إلينا بمصر في الأيام الناصرية سقى الله تعالى عهدها رسولٌ من هذا الأمام بكتاب أطال الشكوى من صاحب اليمن، وعدد قبائحه، ونشر على عيون الناس فضائحه، واستنصر بمددٍ يأتي تحت الأعلام المنصورة لإجلائه عن دياره، وإجرائه مجرى الذين ظلموا في تعجيل دماره.قال: إنه إذا حضرت الجيوش المؤيدة قام معها، وقاد إليها الأشراف والعرب أجمعها، ثم إذا استنقذ منه ما بيده أنعم عليه ببعضه، وأعطي منه ما هو إلى جانب أرضه، قال: فكتبت إليه مؤذناً بالأجابة، مؤدياً إليه ما يقتضي إعجابه، وضمن الجواب أنه لا رغبة لنا في السلب، وأن النصرة تكون لله خالصةً وله كل البلاد لا قدر ما طلب.وسيأتي ذكر المكاتبة إلى هذا الأمام عن الأبواب السلطانية في الكلام على المكاتبات في المقالة الرابعة فيما بعد إن شاء الله تعالى.القطر الثاني مما هو خارج من جزيرة العرب عن مضافات الديار المصرية بلاد البحرين:تثنية بحر، قال في تقويم البلدان: بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المهملة وسكون المثناة من تحت ثم نون، وهي قطعة من جزيرة العرب المذكورة.قال في تقويم البلدان: وهي ناحية من نواحي نجد، على شط بحر فارس، ولها قرى كثيرة، قال وهي هجر ونهايتها الشرقية الشمالية قال في الأطوال ونهايتها من الشمال في الإقليم الثاني حيث الطول أربع وسبعون درجة وعشرون دقيقة، والعرض خمسٌ وعشرون درجةً وخمس وأربعون دقيقة.قال في المشترك: ويقال للبحرين هجر أيضاً- بفتح الهاء والجيم ثم راء مهملة وليست هجر مدينةً بعينها. قال الأزهري: وإنما سميت هجر بالبحرين ببحيرة بها عند الأحساء، وبالبحر الملح يعني فارس، والنسبة إلى البحرين بحراني.قال الجوهري: والنسبة إلى هجر هاجري على غير قياس. قال الأزهري: وسميت هجر بهجر بنت المكنف، وهي التي بنتها.وفيها ثلاث جمل:الجملة الأولى فيما تشتمل عليه من المدن:وقاعدتها عمان قال في اللباب: بضم العين المهملة وفتح الميم ونون في الآخر بعد الألف. قال الأزهري: وسميت بعمان بن نعسان بن إبراهيم عليه السلام، وموقعها في الإقليم الأول.قال: وهي على البحر تحت البصرة. قال المهلبي: وهي مدينة جليلة، بها مرسى السفن من السند والهند والزنج، وليس على بحر فارس مدينةٌ أجل منها، وأعمالها نحو ثلثمائة فرسخ، قال: وهي ديار الأزد قال في تقويم البلدان: وهي بلدة كثيرة النخل والفواكه، ولكنها حارة جداً. وكانت القصبة في القديم مدينة صحار. قال في تقويم البلدان: بضم الصاد وفتح الحاء المهملتين كما في الصحاح. قال: وهي اليوم خراب.وبها بلاد أخرى غير ذلك.منها الأحساء. قال في تقويم البلدان: بفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح السين المهملتين وألفٍ في الآخر. قال في المشترك: والأحساء جمع حسي، وهو رمل يغوص فيه الماء، حتى إذا صار إلى صلابة الأرض أمسكته فتحفر عنه العرب وتستخرجه. وموقعها في أوائل الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة.قال في الأطوال: حيث الطول ثلاثٌ وسبعون درجة وثلاثون دقيقة، والعرض اثنتان وعشرون درجة. قال في تقويم البلدان: ذات نخيل كثير، ومياه جارية، ومنابعها حارة شديدة الحرارة، ونخيلها بقدر غوطة دمشق، وهو مستدير عليها، وهي في البرية في الغرب عن القطيف بميلة إلى الجنوب، على مرحلتين منها.قال: وتعرف بأحساء بني سعد.ومنها القطيف. قال في اللباب: بفتح القاف وكسر الطاء المهملة وسكون المثناة من تحت وفاءٍ في الآخر. وهي بلدةٌ على مرحلتين من الأحساء من جهة الشرق والشمال، واقعة في الإقليم الثاني من لأقاليم السبعة. قال في تقويم البلدان: والقياس أنها حيث الطول ثلاث وسبعون درجة وخمس وخمسون دقيقة، والعرض اثنتان وعشرون درجة وخمسٌ وثلاثون دقيقة. قال في تقويم البلدان: وهي على شط بحر فارس، وبها مغاص لؤلؤ، وبها نخيلٌ دون نخيل الأحساء. قال: وعن بعض أهلها أن لها سوراً وخندقاً ولها أربعة أبواب، والبحر إذا مد يصل إلى سورها وإذا جزر ينكشف بعض الأرض، وهي أكبر من الأحساء، قال: ولها خور في البحر تدخل فيه المراكب الكبار الموسقة في حالة المد والجزر، بينها وبين البصرة ستة أيام، وبينها وبين عمان مسيرة شهر.ومنها كاظمة. قال في تقويم البلدان: بكاف وألف وظاءٍ معجمة مكسورةٍ وميم وهاء. قال: وهي جون على ساحل البحر، بين البصرة والقطيف، في سمت الجنوب عن البصرة، وبينها وبين البصرة مسيرة يومين، وبينها وبين القطيف أربعة أيام.الجملة الثانية في ذكر ملوكها:قد ذكر صاحب العبر: أنها كانت في القديم لعادٍ مع حضرموت والشحر وما والأهما، ثم غلب عليها بعد ذلك بنو يعرب بن قحطان.الجملة الثالثة في الطريق الموصل إليها:قد تقدم في الكلام على مملكة إيران الطريق من مملكة مصر إلى البصرة.قال ابن خرداذبه: ثم من البصرة إلى عبادان، ثم إلى الحدوثة، ثم إلى عرفجاء، ثم إلى الزأبوقة، ثم إلى المغز، ثم إلى عصا، ثم إلى المعرس، ثم إلى خليجة، ثم إلى حسان، ثم إلى القرى، ثم إلى مسيلحة، ثم إلى حمض، ثم إلى ساحل هجر، ثم إلى العقير، ثم إلى القطن، ثم إلى السبخة، ثم إلى عمان.ثم إلى مرسى حلي، ثم إلى مرسى ضنكان، ثم إلى سجين، ثم إلى مخلاف الحكم، ثم إلى الجودة، ثم إلى مخلاف عك، ثم إلى غلافقة، ثم إلى مخلاف زبيد، ثم إلى المندب، ثم إلى مخلاف الركب، ثم إلى المنجلة، ثم إلى مخلاف بني مجيد، ثم إلى مغاص اللؤلؤ، ثم إلى عدن، ثم إلى مخلاف لحج، ثم إلى قرية عبد الله بن مذحج، ثم إلى مخلاف كندة، ثم إلى الشحر، ثم إلى ساحل هماه، ثم إلى عوكلان، ثم إلى فرق، ثم إلى عمان، وهي طريق بعيدة.ولعربها مكاتبات عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية، على ما سيأتي ذكره في الكلام على المكاتبات في المقالة الرابعة إن شاء الله تعالى.القطر الثالث مما هو خارج من جزيرة العرب عن مضافات الديار المصرية: اليمامة:قال في تقويم البلدان: بفتح المثناة من تحت والميم وألف وميم وهاء في الآخر. وهي قطعةٌ من جزيرة العر بـ من الحجاز، وعليه جرى الفقهاء فحكموا بتحريم مقام الكفر بها كما بسائر أقطار الحجاز، وهي في سمت الشرق عن مكة المشرفة.قال البيهقي: وهي ملك منقطع بعمله، ويحدها من جهة الشرق البحرين، ومن الغرب أطراف اليمن، ومن الشمال نجد والحجاز، وأرضها تسمى العروض: لاعتراضها بين الحجاز والبحرين، وطولها عشرون مرحلةٍ. وهي من جهة الغرب عن القطيف، وبينهما نحو أربع مراحل، وبينها وبين مكة أربعة أيام، وسميت اليمامة باسم امرأة: وهي اليمامة بنت سهم بن طسم، وكانت تنزلها إلى أن قتلها عبد كلال وصلبها على بابها فسميت بها، سماها بذلك تبعٌ آخر.قال في تقويم البلدان: وكان اسمها في القديم جوا بفتح الجيم وسكون الواو. قال في تقويم البلدان: وهي عن البصرة على ست عشرة مرحلة، وعن الكوفة مثل ذلك. قال في تقويم البلدان: وبها من القرب عين ماء متسعةٌ وماؤها سارحٌ، وذكر أنها أكثر نخيلاً من سائر الحجاز، ثم نقل عمن رآها في زمانه أن بها آباراً وقليل نخل، وكأنه حكى معبراً عما كانت عليه في القدم، وبها وادٍ يسمى- الخرج- بخاء معجمة مفتوحة وراءٍ مهملة ساكنة وجيم الآخر، كما هو مضبوط في الصحاح.وفيها ثلاث جمل:الجملة الأولى فيما اشتملت عليه من البلدان:قد ذكر في تقويم البلدان: عمن أخبره ممن رآها في زمانه أنها بها عدة قرى.وبها الحنطة والشعير كثير، وقاعدتها دون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واقعةٌ في أوائل الإقليم الثاني. قال في الأطوال: حيث الطول إحدى وسبعون درجةً وخمس وأربعون دقيقةً، وعرض إحدى وعشرون درجةً وثلاثون دقيقةً.ومن بلادها حجر قال في المشترك: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وراء مهملة في الآخر. وهي في الغرب عن مدينة اليمامة، على مرحلتين منها. وبعضهم يجعلها قاعدة اليمامة، وموقعها في أوائل الإقليم الثاني.قال في تقويم البلدان: والقياس أنها حيث الطول إحدى وسبعون درجةً وعشر دقائق، والعرض اثنتان وعشرون درجة. وقال: وبها قبور الشهداء الذين قتلوا في حرب مسلمة الكذاب.الجملة الثانية في ذكر ملوكها:قال صاحب العبر: كانت هي والطائف بيدد بني هزان بن يعفر بن السكسك، إلى أن غلبهم عليها طسم. ثم غلبها عليها جديس، ومنهم زرقاء اليمامة، ثم استولى عليها بنو حنيفة وكان منهم هوذة بن علي، وهو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. ثم ملكها من بني حنيفة ثمامة بن أثال على عهد النبي صلى الله عليه وسالم، وأسر ثم أسلم، ثم كان بها منهم مسلمة الكذاب زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل في حرب المسلمين معه.وكان لبني الأخيضر من الطالبيين بها دولةٌ.وأول من ملكها منهم محمد بن الأخيضر بن يوسف، بن إبراهيم، بن موسى الجون، بن عبد الله، بن الحسن المثنى، بن الحسن السبط؛ ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.وكان استيلاؤه عليها أيام المستعين الخليفة العباسي. ثم ملكها بعده ابنه يوسف ثم ابنه الحسن ثم ابنه أحمد ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة، على ما تقدم ذكره في الكلام على بلاد البحرين.قال ابن سعيد: وسألت عرب البحرين في سنة، لمن اليمامة اليوم؟ فقالوا لعربٍ من قيس عيلان وليس لبني حنيفة بها ذكر.قلت ولم أقف لعربها على ذكر ما في المكاتبات السلطانية بالديار المصرية.الجملة الثالثة في الطريق الموصل إليها:قد تقدم أنها في جهة الشرق عن مكة، وأن بينهما أربعة أيام، وطريق مكة معروف على ما تقدم.أما ما ذكره ابن حرداذبه من طريقها على البصرة- فمن البصرة إلى المنشجانية، ثم إلى الكفير، ثم إلى الرحيل، ثم إلى الشجي، ثم إلى الحفر، ثم إلى ماوية، ثم إلى ذات العشر ثم إلى الينسوعة، ثم إلى السمينة، ثم إلى النباج؛ ثم إلى العمومية، ثم إلى القريتين، ثم إلى سويقة، ثم إلى صداة، ثم إلى السد، ثم إلى السقي، ثم إلى المنبية، ثم إلى السفح، ثم إلى المريقة، ثم إلى اليمام، والبصرة قد تقدم أكثر الطريق إليها في الكلام على مملكة إيران.القطرالرابع: مملكة الهند ومضافاتها:قال في مسالك الأبصار: وهي مملكة عظيمة الشأن لا تقاس في الأرض بمملكة سواها: لاتساع أقطارها، وكثرة أموالها وعساكرها، وأبهة سلطانها في ركوبه ونزوله، ودست ملكه، وفي صيتها وسمعتها كفايةٌ. ثم قال: ولقد كنت أسمع من الأخبار الطائحة والكتب المصنفة ما يملأ العين والسمع، وكنت لا أقف على حقيقة أخبارها لبعدها منا، وثنائي ديارها عنا، ثم تتبعت ذلك من الرواة، فوجدت أكثر مما كنت أسمع، وأجل مما كنت أظن. وحسبك ببلاد في بحرها الدر، وفي برها الذهب، وفي جبالها الياقوت والماس، وفي شعابها العود والكافور، وفي مدنها أسرة الملوك؛ ومن وحوشها الفيل والكركدن، ومن حديدها سيوف الهند، وأسعارها رخية، وعساكرها لا تعد، وممالكها لا تحد، ولأهلها الحكمة ووفور العقل، وهم أملك الأمم لشهواتهم وأبذلهم للنفوس فيما يظن به الزلفى.قال: وقد وصف محمد بن عبد الرحيم الأقليشي هذه المملكة في كتابه تحفة الألباب فقال: الملك العظيم، والعدل الكثير، والنعمة الجزيلة، والسياسة الحسنة والرضا الدائم، والأمن الذي لا خوف معه في بلاد الهند. وأهل الهند أعلم الناس بأنواع الحكمة والطب والهندسة والصناعات العجيبة ثم قال: وفي جبالهم وجزائرهم ينبت شجر العود والكافور وجميع أنواع الطيب: كالقرنفل والسنبل والدارصيني، والقرفة، والسليخة والقاتلة، والكبابة، والبسباسة وأنواع العقاقير. وعندهم غزال المسك وسنور الزباد، هذا مع ما هذه المملكة عليه من اتساع الأقطار، وتباعد الأرجاء، وتنائي الجوانب.فقد حكى في مسالك الأبصار: عن الشيخ مبارك بن محمود الأنباتي: أن عرض هذه المملكة ما بين سومنات وسرنديب إلى غزنة، وطولها من الفرضة المقابلة لعدن إلى سد الإسكندر عند مخرج البحر الهندي، من البحر المحيط، وأن مسافة ذلك ثلاث سنين في مثلها بالسير المعتاد، كلها متصلة المدن ذوات المنابر والأسرة والأعمال، والقرى، والضياع، والرساتيق، والأسواق، لا يفصل بينها خراب، بعد أن ذكر عنه أنه ثقة ثبت عارف بما يحكيه إلا أنه استبعد هذا المقدار، وقال: إن جميع المعمور لا يفي بهذه المسافة، اللهم إلا أن يريد أن هذه مسافة من يتنقل فيها حتى يحيط بجميعها مكاناً مكاناً، فيحتمل على ما فيه.وفيه إحدى عشرة جملةً.الجملة الأولى فيما اشتملت عليه هذه المملكة من الأقاليم:وتحتوي هذه المملكة على إقليمين عظيمين:الإقليم الأول: إقليم السند:وما انخرط في سلكه من مكران، وطوران، والبدهة، وبلاد القفس والبلوص فأما السند، فبكسر السين المهملة وسكون النون ودال مهملة في الآخر. قال ابن حوقل: ويحيط به من جهة الغرب حدود كرمان، وتمام الحد مفازة سجستان؛ ومن جهة الجنوب مفازة هي فيما بين كرمان والبحر الهندي، والبحر جنوبي المفازة، ومن جهة الشرق بحر فارس أيضا: لأن البحر يتقوس على كرمان والسند، حتى يصير له دخلة شرقي بلاد السند؛ ومن جهة الشمال قطعة من الهند. قال ابن خرداذبة: وبالسند القسط، والقنا، والخيزران.وقاعدته المنصورة- قال في تقويم البلدان: بفتح الميم وسكون النون وضم الصاد المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة وهاء في الآخر.وهي مدينة بالسند واقعة في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال ابن سعيد: حيث الطول خمس وتسعون درجة وثلاثون دقيقة، والعرض أربع وعشرون درجة واثنتان وأربعون دقيقة. قال في القانون: واسمها القديم يمنهو وإنما سميت المنصورة لأن الذي فتحها من المسلمين قال نصرنا. وقال المهلبي: إنما سميت المنصورة لأن عمر بن حفص المعروف بهزارمرد بناها في أيام أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس وسماها بلقبه.قال ابن حوقل: وهي مدينة كبيرة يحيط بها خليج من نهر مهران وهو نهر يأتي من الملتان فهي كالجزيرة ولكنها بلدة حارة وليس بها سوى النخيل، وبها قصب السكر، وبها أيضا ثمر على قدر التفاح شديد الحموضة، يسمى اليمومة.وبها عدة مدن وبلادٍ أيضاً.منها الديبل- قال في اللباب: بفتح الدال المهملة وسكون المثناة من تحتها وضم الباء الموحدة ولام في الآخر. وهي بلدة على ساحل البحر، واقعة في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال ابن سعيد: حيث الطول اثنتان وتسعون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة، والعرض أربع وعشرون درجة وعشرون دقيقة. قال في تقويم البلدان: وهي بلدة صغيرة على ساحل ماء السند شديدة الحر. قال ابن حوقل: وهي شرقي مهران، وهي فرضة تلك البلاد. وقال في اللباب: إنها على البحر الهندي قريبة من السند. قال ابن سعيد: وهي في دخلة من البر في خليج السند، وهي أكبر فرض السند وأشهرها؛ ويجلب منها المتاع الديبلي. قال في تقويم البلدان: وبها سمسم كثير، ويجلب إليها التمر من البصرة، وبينها وبين المنصورة ست مراحل.ومنها البيرون. قال في اللباب: بكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وضم الراء المهملة وبعدها واو ونون في الآخر. وهي مدينة من أعمال الديبل بينها وبين المنصورة، واقعة في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول أربع وتسعون درجة وثلاثون دقيقة، والعرض أربع وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقة. قال ابن سعيد: وهي من فرض بلاد السند التي عليها خليجهم المالح الخارج من بحر فارس. قال في العزيزي وأهلها مسلمون، ومنها إلى المنصورة خمسة عشر فرسخاً. قال ابن سعيد: وإليها ينسب أبو الريحان البيروني، يعني صاحب القانون في أطوال البلاد وعروضها.ومنها سدوسان. قال في تقويم البلدان: بفتح السين وضم الدال المهملتين وواو ثم سين مهملة ثانية مفتوحة وألف ونون. وهي مدينة غربي نهر مهران، واقعة في أوائل الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول أربع وتسعون درجة وخمسون دقيقة، والعرض ثمان وعشرون درجة وعشر دقائق. قال ابن حوقل: وهي خصبة كثيرة الخير وحولها قرًى ورستاق، وهي ذات أسواق جليلة.ومنها المولتان قال في تقويم البلدان: بضم الميم وسكون اللام ثم تاء مثناة فوقية وألف ونون. قال: وهي في أكثر الكتب مكتوبة بواو. وهي مدينة من السند فيما ذكره أبو الريحان البيروني، وإن كان ابن حوقل جعلها من الهند وعليه جرى في مسالك الأبصار لأن البيروني أقعد بذلك منه: لأن السند بلاده فهو بها أخبر، واقعة في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة. قال في القانون: حيث الطول ست وتسعون درجة وخمس وعشرون دقيقةً، والعرض ثمانٌ وعشرون درجة وأربعون دقيقة. قال ابن حوقل: وهي أصغر من المنصورة.وقد ذكر في مسالك الأبصار عن بعض المصنفات أن قرى الملتان مائة ألف قرية وستة وعشرون ألف قرية. قال المهلبي: وأعمال الملتان واسعةٌ من قرب حد مكران من الجنوب إلى حد المنصورة، وبينها وبين غزنة ثمانية وستون فرسخاً.ومنها أزور. قال ابن حوقل: وهي مدينةٌ تقارب الملتان في الكبر، وعليها سوران وهي على نهر مهران. وقال في العزيزي: هي مدينةٌ كبيرة وأهلها مسلمون في طاعة صاحب المنصورة وبينهما ثلاثون فرسخاً، قال في القانون: حيث الطول خمسٌ وتسعون درجة وخمسٌ وخمسون دقيقة، والعرض ثمانٌ وعشرون درجة وعشر دقائق.وأما مكران، فقال في اللباب: بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء المهملة وألف ونون. قال ابن حوقل: وهي ناحية واسعة عريضة، والغالب عليها المفاوز والقحط والضيق. وقد اختلف كلام صاحب تقويم البلدان فيها فذكر في الكلام على السند أنها منه، وذكر في كلامه على مكران في ضمن بلاد السند أنها من كرمان.وقاعدتها التيز قال في اللباب: بالتاء المثناة الفوقية الممالة ثم ياء آخر الحروف وزاي معجمة في الآخر، وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال ابن سعيد: حيث الطول ستٌّ وثمانون درجة، والعرض ست وعشرون درجة وخمس عشرة دقيقة. قال ابن حوقل: وهي فرضة مكران وتلك النواحي، وهي على شط نهر مهران في غربيه بقرب الخليج المنفتح من مهران على ظهر المنصورة.وأما طوران. فناحية على خمس عشرة مرحلةً من المنصورة. قال في القانون: وقصبتها قندابيل قال: وهي حيث الطول خمسٌ وتسعون درجةً، والعرض ثمانٌ وعشرون درجة.وذكر ابن حوقل أن قصبة طوران قزدار قال في اللباب: بضم القاف وسكون الزاي المعجمة وفتح الدال المهملة وألف وراء مهملة. وقد نقل في تقويم البلدان عن إخبار من رآها أنها قليعة. قال في تقويم البلدان: وهي كالقرية لصغرها، وهي في وطاءة من الأرض على تليل، وحولها بعض بساتين. وذكر في الباب أن قزدار ناحيةٌ من نواحي الهند. قال في تقويم البلدان: وبينها وبين الملتان نحو عشرين مرحلة.وأما البدهة، فقال ابن حوقل: وهي مفترشةٌ ما بين حدود طوران ومكران والملتان ومدن المنصورة؛ وهي في غربي نهر مهران، وأهلها أهل إبلٍ كالبادية، ولهم أخصاصٌ وآجامٌ. قال في تقويم البلدان: ومن المنصورة إلى أول البدهة خمس مراحل، ومن أراد البدهة من المنصورة احتاج إلى عبور نهر مهران.الإقليم الثاني: إقليم الهند:قال في الأنساب: بكسر الهاء وسكون النون ودالٍ مهملة في الآخر. قال في تقويم البلدان: والذي يحيط به من جهة الغرب بحر فارس، وتمامه حدود السند، ومن جهة الجنوب البحر الهندي، ومن جهة الشرق المفاوز الفاصلة بين الهند والصين، ولم يذكر الحد الذي من جهة الشمال. وذكر في مسالك الأبصار أن حده من جهة الشمال بلاد الترك. وذكر عن الشيخ مبارك الأنباتي: أنه ليس في هذه المملكة خراب سوى مسافة عشرين يوماً مما يلي غزنة، لتجاذب صاحب الهند وصاحب تركستان وما وراء النهر بأطراف المنازعة، أو جبال معطلة، أو شعواء مشتبكة.قال صاحب مسالك الأبصار: وسألت الشيخ مبارك الأنباتي عن بر الهند وضواحيه فقال: إن به أنهاراً ممتدة تقارب ألف نهر كبار وصغار، منها ما يضاهي النيل عظماً، ومنها ما هو دونه، ومنها ما هو مثل بقية الأنهار. وعلى صغار الأنهار القرى والمدن؛ وبه الأشجار الكثيفة والمروج الفيح. قال: وهي بلادٌ معتدلة لا تتفاوت حالأت فصولها، ليست مفرطةً في حرٍّ ولا برد، بل كأن كل أوقاتها ربيع، وتهب بها الأهوية والنسيم اللطيف، وتتوالى بها الأمطار مدة أربعة أشهر، وأكثرها في أخريات الربيع إلى ما يليه من الصيف.ثم لمملكة الهند قاعدتان:القاعدة الأولى: مدينة دلّي:قال في تقويم البلدان: بدالٍ مهملة ولامٍ مشددة مكسورة ثم مثناة تحتية، ولم يتعرض لضبط الدال والناس ينطقون بها بالفتح وبالضم. وسماها صاحب تقويم البلدان في تاريخه دهلي بابدال اللام هاء. وهي مدينةٌ ذات إقليمٍ متسع، وموقعها في الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول مائةٌ وثمانٌ وعشرون درجة وخمسون دقيقة، والعرض خمسٌ وثلاثون درجة وخمسون دقيقة. قال في تقويم البلدان: وهي مدينةٌ كبيرة في مستوٍ من الأرض، وتربتها مختلطة بالحجر والرمل، وعليها سور من آجرٍّ، وسورها أكبر من سور حماة، وهي بعيدة من البحر، ويمر على فرسخ منها نهرٌ كبير دون الفرات، وبها بساتين قليلة وليس بها عنب، وتمطر في الصيف؛ وبجامعها منارة لم يعلم في الدنيا مثلها، مبنية من حجرٍ أحمر ودرجها نحو ثلثمائة درجةٍ؛ وهي كبيرة الأضلاع، عظيمة الأوضاع واسعة الأسفل وارتفاعها يقارب منارة الإسكندرية.وذكر في مسالك الأبصار عن الشيخ برهان الدين بن الخلال البزي الكوفي: أن علوها في نحو ستمائة ذراع. وذكر عن الشيخ مبارك الأنباتي أن دلّي مدائن جمعت ولكل مدينةٍ منها اسمٌ يخصها ودلّي واحدة منها. قال الشيخ أبو بكر ابن الخلال: وجملة ما يطلق عليه الآن اسم دلّي إحدى وعشرون مدينةً.قال الشيخ مبارك: وهي مميلة طولاً وعرضاً، ويكون دور عمرانها أربعين ميلاً، وبناؤها بالحجر والأجرّ، وسقوفها بالخشب، وأرضها مفروشةٌ بحجرٍ أبيض شبيهٍ بالرخام، ولا يبنى بها أكثر من طبقتين وربما اقتصر على طبقةٍ واحدة، ولا يفرش دوره فيها بالرخام إلا السلطان. قال: وفيها ألف مدرسةٍ، منها مدرسةٌ واحدة للشافعية وباقيها للحنفية، وبها نحو سبعين بيمارستاناً، وتسمى بها دور الشفاء! وبها وببلادها من الربط والخوانق نحو ألفين، وفيها الزيارات العظيمة، والأسواق الممتدة، والحمامات الكثيرة؛ وشرب أهلها من ماء المطر، تجتمع الأمطار فيها في أحواضٍ وسيعة كل حوضٍ قطره غلوة سهمٍ أو أكثر. أما مياه الاستعمال وشرب الدواب فمن آبارٍ قريبة المستقى، أطول ما فيها سبعة أذرع. وقد صارت دلّي قاعدةً لجميع الهند ومستقر السلطان وبها قصورٌ ومنازل خاصةٌ بسكنه وسكن حريمه، ومقاصير جواريه وحظاياه وبيوت خدمه ومماليكه، لا يسكن معه أحدٌ منالخانات ولا من الأمراء، ولا يكون بها أحد منهم إلا إذا حضر للخدمة ثم ينصرف كل واحدٍ منهم إلى بيته. ولها بساتين من جهاتها الثلاث: الشرق، والجنوب، والشمال على استقامة. كل خط اثنا عشر ميلاً، أما الجهة الغربية فعاطلة من ذلك لمقاربة جبل لهابة. ووراء ذلك مدنٌ وأقاليمٌ متعددة.القاعدة الثانية: مدينة الدواكير:ومدينة الدواكير بفتح الدال المهملة والواو وألفٍ بعدها كاف مكسورة ثم ياء مثناة تحتية وراء مهملة في الآخر. وهي مدينةٌ ذات إقليمٍ متسع. وقد ذكر في مسالك الأبصار عن الشيخ مبارك الأنباتي: أنها مدينةٌ قديمة جددها السلطان محمد بن طغلقشاه، وسماها قبة الإسلام. وذكر أنه فارقها ولم تتكامل بعد، وأن السلطان المذكور كان قد قسمها على أن تبنى محلات لأهل كل طائفةٍ محلة: الجند في محلة، والوزراء في محلة، والكتاب في محلة، والقضاة والعلماء في محلة، والمشايخ والفقراء في محلة، وفي كل محلة ما يحتاج إليه من المساجد، والأسواق، والحمّامات، والطواحين، والأفران، وأرباب الصنائع من كل نوع حتى الصواغ والصباغين، والدباغين، بحيث لا يحتاج أهل محلة إلى أخرى في بيعٍ ولا شراء، ولا أخذٍ ولا عطاء: لتكون كل محلة كأنها مدينة مفردة قائمة بذاتها.واعلم أن صاحب تقويم البلدان: قد ذكر عن بعض المسافرين إلى الهند أن بلاد الهند على ثلاثة أقسام.القسم الأول- بلاد الجزرات.قال في تقويم البلدان: بالجيم والزاي المعجمة والراء المهملة ثم ألف وتاء مثناة فوق. وبها عدة مدن وبلاد.منها نهلوارة بالنون والهاء واللام والواو ثم ألفٍ وراءٍ مهملة وهاء. قال ابن سعيد: نهر والة، فقدم الراء وأخر اللام، وكذلك نقله في تقويم البلدان عن بعض المسافرين. وفي نزهة المشتاق نهر وارة براءين. وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول ثمانٌ وتسعون درجة وعشرون دقيقة، والعرض ثلاثٌ وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة. وهي غربي إقليم المنيبار الأتي ذكره. قال: وهي أكبر من كنبايت، وعمارتها مفرقة بين البساتين والمياه، وهي عن البحر على مسيرة ثلاثة أيام. قال صاحب حماة في تاريخه: وهي من أعظم بلاد الهند.ومنها كنبايت قال في تقويم البلدان: بالكاف ونونٍ ساكنة وباءٍ موحدة ثم ألفٍ وياء مثناة تحتية وتاء مثناة من فوقها، ومقتضى ما في مسالك الأبصار: أن يكون اسمها أنبايت بإبدال الكاف همزة، فإنه ينسب إليها أنباتي. وهي مدينةٌ على ساحل بحر الهند، موقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول تسعٌ وتسعون درجةً وعشرون دقيقة، والعرض اثنتان وعشرون درجة وعشرون دقيقة. وذكر في تقويم البلدان عمن سافر إليها أنها غربي المنيبار على خور من البحر طوله مسيرة ثلاثة أيام. قال: وهي مدينةٌ حسنةٌ، أكبر من المعرة من الشام في المقدار، وأبنيتها بالأجر، وبها الرخام الأبيض وبها بساتين قليلة.ومنها تانة. قال في تقويم البلدان: قال أبو العقول نقلاً عن عبد الرحمن الريان الهندي- بفتح المثناة الفوقية ثم ألفٍ ونونٍ وهاء وهي بلدةٌ على ساحل البحر، واقعةٌ في الإقليم الأول من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول مائةٌ وأربع عشرة درجة وعشرون دقيقةً، والعرض تسع عشرة درجة وعشرون دقيقة. قال في تقويم البلدان: وهي من مشارق الجزرات. قال ابن سعيد: وهي مشهورةٌ على ألسن التجار. قال: وأهل هذا الساحل جميعهم كفار يعبدون الأنداد، والمسلمون ساكنون معهم. قال الأدريسي: وأرضها وجبالها تنبت القنا والطباشير ويحمل منها إلى الأفاق. قال أبو الريحان: والنسبة إليها تانشي ومنها الثياب التانشية.ومنها صومنات قال في تقويم البلدان: بالصاد المهملة ويقال بالسين المهملة ثم واوٍ ساكنة وميم ونون مفتوحتين ثم ألفٍ وتاء مثناة فوقية في الآخر، وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول سبعٌ وتسعون درجة وعشر دقائق، والعرض اثنتان وعشرون درجة وخمس عشرة دقيقة. قال في القانون: وهي على الساحل في أرض البوازيج. قال ابن سعيد: وهي مشهورةٌ على ألسنة المسافرين، وتعرف ببلاد اللار، وموضعها في جهةٍ داخلةٍ في البحر فينطحها كثيرٌ من مراكب عدن لأنها ليست في جون، ولها خور ينزل من الجبل الكبير الذي في شماليها إلى شرقيها، وكان بها صنم تعظمه الهنود يضاف إليها، فقال: صنم صومنات فكسره يمين الدولة محمود بن سبكتكين عند فتحها كما هو مذكور في التاريخ.ومنها سندان بالسين المهملة والنون والدال المهملة والألف والنون، هكذا ذكره في تقويم البلدان: ونقل لفظه عن المهلبي في العزيزي: وقال بعض المسافرين إنها سندأبور بالسين المهملة والنون والدال المهملة وألفٍ وباء موحدة وراءٍ مهملة في الآخر. وهي مدينةٌ على ثلاثة أيام من تانة، موقعها في الإقليم الأول من الأقاليم السبعة قال في القانون: حيث الطول مائةٌ وأربع درج وعشرون دقيقة، والعرض تسع عشرة درجة وعشرون دقيقة. قال في تقويم البلدان عن بعض المسافرين: وهي على جونٍ في البحر الأخضر، وهي آخر إقليم الجزرات. قال في القانون: وهي على الساحل. قال في العزيزيي: وبينها وبين المنصورة خمسة عشر فرسخاً، وهي مجمع الطرق. قال: وهي بلاد القسط والقنا والخيزران، وهي من أجل الفرض التي على البحر.ومنها ناكور قال في تقويم البلدان: بفتح النون وألفٍ وكاف مضمومة وواوٍ وراءٍ مهملةٍ في الآخر. وهي مدينةٌ على أربعة أيام من دلي.ومنها جالور بفتح الجيم ثم ألفٍ ولام مضمومة وواوٍ وراءٍ مهملة. وهي على تل ترابٍ نحو قلعة مصياف بين ناكور وبين نهروالة. ويقال إنه لم يعص على صاحب دلي من الجزرات غير جالور.ومنها منوري. قال في القانون: وهي بين الفرضة وبين المعبر إلى سرنديب حيث الطول مائةٌ وعشرون درجة، والعرض ثلاث عشرة درجة.القسم الثاني من إقليم الهند بلاد المنيبار.قال في تقويم البلدان: بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ثم ألفٍ وراءٍ مهملةٍ في الآخر. وهي إقليمٌ من أقاليم الهند في الشرق عن بلاد الجزرات المقدم ذكرها. قال: والمنيبار هي بلاد الفلفل. ثم قال: والفلفل في شجره عناقيدٌ كعناقيد الدخن، وشجره ربما التف على غيره من الأشجار كما تلتف الدوالي، وبها بلاد كثيرة وجميع بلاد المنيبار مخضرة كثيرة المياه والأشجار الملتفة.ومنها هنور قال في تقويم البلدان: بفتح الهاء والنون المشددة والواو وراءٍ مهملة. وهي غربي سندأبور من بلاد الجزرات المقدم ذكرها، فتكون أول بلاد المنيبار من الغرب. قال: ولها بساتين كثيرة.ومنها باسرور بالباء الموحدة وبالسين المفتوحة والراءين المهملات. وهي بلدةٌ صغيرة شرقي هنور المقدمة الذكر.ومنه منجرور قال في تقويم البلدان: بفتح الميم وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء المهملة ثم واوٍ ساكنة وراءٍ مهملة وهي شرقي باسرور المقدمة الذكر. قال: وهي من أكبر بلاد المنيبار، وملكها كافر، ووراءها بثلاثة أيام جبلٌ عظيمٌ داخل في البحر، يرى للمسافرين من بعد، ويسمى رأس هيلي بفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت وكسر اللام ثم ياءٍ مثناة تحتية في الآخر.ومنها تنديور بالتاء المثناة الفوقية المفتوحة وسكون النون ثم دالٍ مهملة وياءٍ آخر الحروف مضمومة وواوٍ وراءٍ مهملة. وهي بليدة شرقي رأس هيلي لها بساتين كثيرةٌ.ومنها الشاليات بفتح الشين المعجمة وألفٍ ولامٍ وياء آخر الحروف ثم ألفٍ وتاءٍ مثناة فوقية.ومنها الشنكلي بالشين المعجمة المكسورة وسكون النون وكافٍ ولام وياء آخر الحروف. وهي بلدةٌ بالقرب من الشاليات.ومنه الكولم قال في تقويم البلدان: بالكاف المفتوحة والواو الساكنة ثم لام مفتوحة وميم في الآخر، وموقعها في الإقليم الأول من الأقاليم السبعة قال في الأطوال: حيث الطول مائةٌ وعشر درجات، والعرض ثمان عشرة درجة وثلاثون دقيقة. قال ابن سعيد: وهي آخر بلاد الفلفل من الشرق، ومنها يقلع إلى عدن. قال صاحب تقويم البلدان: وحكى لي بعض المسافرين أنها على خور من البحر في مستوٍ من الأرض وأرضها مرملة، وهي كثيرة البساتين، وبها شجر البقم: وهو شجرٌ كشجر الرمان، وورقه يشبه ورق العناب، وفيها حارةٌ للمسلمين وبها جامعٌ.القسم الثالث- من إقليم الهند بلاد المعبر.قال في تقويم البلدان: بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم راء مهملة، وهي شرقي بلاد الكولم بثلاثة أيام وأربعة، قال في تقويم البلدان: وينبغي أن تكون بميلة إلى الجنوب. قال ابن سعيد: وهو مشهور على الألسن، ومنه يجلب اللانس. وبها يضرب المثل في قصاريها. قال: وفي شماليها جبالٌ متصلةٌ ببلاد بلهرا ملك ملوك الهند، وفي غربيها يصب نهر الصوليان في البحر، وذكر في مسالك الأبصار عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي: أن بلاد المعبر تشتمل على عدة جزائر كبارٍ.وبه عدة مدن وبلاد.ومنها بيردأول قال في تقويم البلدان: بكسر الباء الموحدة وتشديد الياء المثناة التحتية وسكون الراء وفتح الدال المهملتين وألفٍ وواو ولام. قال: وهي قصبة بلاد المعبر، وموقعها في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة قال ابن سعيد: حيث الطول مائةٌ واثنتان وأربعون درجة، والعرض سبع عشرة درجة وخمسٌ وعشرون دقيقة. قال في تقويم البلدان: وهي مدينة سلطان المعبر، وإليه تجلب الخيول من البلاد.ثم اعلم أن وراء ما تقدمٌ بلاداً أخرى ذكرها في تقويم البلدان.منها ماهورة قال في تقويم البلدان: بفتح الميم والألف والهاء والواو مهملة وهاء. وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال في القانون حيث الطول مائة درجة وأربع درج، والعرض سبعٌ وعشرون درجة.قال ابن سعيد: وهي على جانبي نهر كنك في انحداره من قنوج إلى بحر الهند.قال في تقويم البلدان: وهي بلد البراهمة، وهم عباد الهند ينسبون إلى البرهمن أول حكمائهم، قال ابن سعيد: وقلاعهم بها لا ترام.ومنها لوهور قال في اللباب: بفتح اللام وسكون الواوين بينهما هاء مفتوحة في الآخر وراء مهملة قال: ويقال لها أيضاً لهاور. وموقعها في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة قال في الأطوال: حيث الطول مائة درجة والعرض إحدى وثلاثون درجةً. قال في اللباب: وهي نمدينة كبيرة كثيرة الخير، خرج منها جماعة من أهل العلم.ومنها قنوج قال في تقويم البلدان: بكسر القاف وفتح النون المشددة والواو ثم جيم. وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة قال ابن سعيد: حيث الطول مائةً وإحدى وثلاثون درجة وخمسون دقيقة، والعرض تسع وعشرون درجة. وذكر في الأطوال الطول بنقص سبع وعشرين درجةً، والعرض بزيادة ست درج. قال ابن سعيد: وهي قاعدة لهاور، وهي بين ذراعين من نهر كنك. وقال المهلبي: هي في أقاصي الهند في جهة الشرق عن الملتان على مائتين واثنتين وثمانين فرسخاً. قال: وهي مصر الهند وأعظم مدن بها.ثم قال: وقد بالغ الناس في تعظيمها حتى قالوا: إن بها ثلثمائة سوق للجوهر، ولملكها ألفان وخمسمائة فيلٍ، وهي كثيرة معادن الذهب. قال في نزهة المشتاق: هي مدينة حسنة، كثيرة التجارات، ومن مدنها قشمير الخارجة، وقشمير الداخلة، قال: وملكها يسمى القنوج باسمها.ومنها جبال قامرون قال في تقويم البلدان: بفتح القاف وألفٍ وميم وراءٍ مهملة ثم واو ونون. وهي حجاز بين الهند والصين، وعدها في القانون من الجزائر، قال: وهي خارجة عن الإقليم الأول من الأقاليم السبعة إلى الجنوب قال في القانون والأطوال: حيث الطول مائة وخمسٌ وعشرون درجة، والعرض عشر درج، ومدينة الملك شرقيها وبها معدن العود القامروني.قلت: وذكر في مسالك الأبصار عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي: أن في مملكة صاحب الهند ثلاثة وعشرين إقليماً، عد منها بعض ما تقدم ذكره: وهي إقليم دهلي، وإقليم الدواكير، وإقليم الملتان، وإقليم كهران، وإقليم سامانا، وإقليم سبوستان، وإقليم وجا، وإقليم هاسي، وإقليم سرستي، وإقليم المعبر، وإقليم تلنك، وإقليم كجرات، وإقليم بدلون، وإقليم عوض، وإقليم القنوج، وإقليم لكنوتي، وإقليم بهار، وإقليم كره، وإقليم ملاوه، وإقليم لهاور، وإقليم كلافور، وإقليم جاجنكز، وإقليم تلنج، وإقليم دور سمند.ثم قال: وهذه الأقاليم تشتمل على ألف مدينةٍ ومائتي مدينة، كلها مدن ذوات نيابات: كبار وصغار، وبجميعها الأعمال والقرى العامرة الأهلة.وقال إنه لا يعرف عدد قراها، الأ أن إقليم القنوج مائةٌ وعشرون لكاً، كل لك مائة ألف قرية، فتكون اثني عشر ألف قرية، وإقليم تلنك ستة وثلاثون لكاً، فيكون ثلاثة الأف ألف وستمائة ألف قرية، وإقليم ملاوه أكبر من إقليم القنوج في الجملة.وحكي عن الشيخ مبارك الأنباتي: أن على لكنوتي مائتي ألف مركب صغار خفافا للسير، إذا رمى الرامي في إحداها سهماً وقع في وسطها لسرعة جريانها، ومن المراكب الكبار ما فيه الطواحين والأفران والأسواق، وربما لم يعرف بعض ركابه بعضاً إلا بعد مدة لاتساعه وعظمه إلى غبر ذلك مما العهدة فيه عليه.واعلم أن ببحر الهند جزائر عظيمة معدودةً في أعماله، يكون بعضها مملكة منفردةً.منها جزيرة سرنديب قال في تقويم البلدان: بفتح السين والراء المهملتين وسكون النون وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحت ثم باء موحدة.قال: ويقال لها جزيرة سنكاديب، كأنه باللسان الهندي، وموقعها خارج عن الإقليم الأول من الأقاليم السبعة إلى الجنوب قال في الأطوال: حيث الطول مائة وعشرون درجةً، والعرض عشر درج.قال ابن سعيد: ويشق هذه الجزيرة جبلٌ عظيم على خط الأستواء، اسمه جبل الرهون، يزعمون أن عليه هبوط آدم عليه السلام. قال ابن خرداذبه: وهو جبل ذاهبٌ في السماء، يراه أهل المراكب على مسيرة عشرين يوماً وأقل وأكثر.وذكرت البراهمة: أن على هذا الجبل أثر قدم آدم عليه السلام: قدم واحدةٌ مغموسة في الحجر، وأنه خطا الخطوة الأخرى إلى الهند، وهو منها على مسيرة يومين أو ثلاثة. قال: وعلى هذا الجبل شبيهٌ بالبرق أبداً، وعليه العود وسائر العطر والأفاويه، وعليه وحواليه الياقوت وألوانه كلها، وفي واديه الماس والسنباذج، وغزال المسك، وسنور الزباد، وفي أنهار هذه الجزيرة البلور، وحولها في البحر مغاصات اللؤلؤ، ونهرها هو المعظم عند الهنود، وقال ابن سعيد: ومدينتها تسمى أغنا. وهي حيث الطول مائة وأربع وعشرون درجة.ومنها جزيرة الرانج قال في تقويم البلدان: والظاهر أنها بالراء المهملة والألف والنون ثم جيم في الآخر، وموقعها في الجنوب عن الإقليم الأول. قال في الأطوال وطولها مائةٌ وثلاث عشر درجةً، ولا عرض لها، وفيها عمارة وزرعٌ ونارجيل وغير ذلك. قال في كتاب الأطوال: وجبالها ترى من جبال اليمن، وبها جبالٌ تشتعل النار فيها دائماً، وترى تلك النار في البحر من مسيرة أيام، وبها حيات، تبتلع الرجل والجاموس، وفي البحر عند لهاور دور وهو مكان يدور فيه الماء، ويخشى على المراكب عنده. قال ابن خرداذبة: وفيها حيات عظام تبتلع الرجل والجاموس والفيل، وفيها شجر الكافور، تظل الشجرة منه مائة إنسان وعجائب لا تحصى.ومنها جزيرة لامري قال في تقويم البلدان: بلامٍ وألفٍ وميمٍ وراءٍ مهملة ثم ياء آخر الحروف، وموقعها في الجنوب عن الإقليم الأول قال في الأطوال: حيث الطول مائةٌ وست وعشرون درجة، والعرض تسع درج. قال في تقويم البلدان: وهي معدن البقم والخيزران.ومنها جزيرة كلة قال في تقويم البلدان: بالكاف واللام وهاء في الآخر. وموقعها في الجنوب عن الإقليم الأول قال في القانون: حيث الطول مائةٌ وثلاثون درجة، ولا عرض لها. قال في تقويم البلدان: وهي فرضة ما بين عمان والصين، قال المهلبي: وفيها مدينة عامرة يسكنها المسلمون وغيرهم وبها معدان الرصاص ومنابت الخيزران وشجر الكافور، وبينها وبين جزائر المهراج عشرون مجرى.ومنها جزيرة المهراج، قال في تقويم البلدان: الظاهر أنها بالميم والهاء والراء المهملة ثم ألف وجيم في الآخر. قال في كتاب الأطوال: وهي جزييرة سريرة، وموقعها في الجنوب من خط الأستواء قال في الأطوال: حيث الطول مائة وأربعون درجة، والعرض في الجنوب درجةٌ واحدة. قال ابن سعيد: وهي عدة جزائر، وصاحبها من أغنى ملوك الهند وأكثرهم ذهباً وفيلةً. وجزيرته الكبيرة هي التي فيها مقر ملكه، وعدها المهلبي في جزائر الصين، وقال: إنها عامرة آهلة، وإنه إذا أقلع المركب منها طالباً للصين واجهه في البحر جبالٌ ممتدةٌ، داخلة في البحر مسيرة عشرة أيام، فإذا قرب المسافرون منها وجدوا فيها أبو أبا وفرجاً في أثناء ذلك الجبل، يفضي كل بابٍ منها إلى بلد من بلدان الصين. وعد ابن سعيد سريرة من جزائر الرانج، وقال: إن طولها من الشمال إلى الجنوب أربعمائة ميل، وعرضها في كل طرف من الجنوبي والشمالي نحو مائة وستين ميلاً؛ وسريرة مدينة في وسطها، ثم يدخل منها جون إلى البحر وهي على نهر.ومنها جزيرة أندرابي قال في تقويم البلدان: بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال والراء المهملتين ثم ألف وباء موحدة وفي الآخر ياء مثناة من تحتها.ومنه جزيرة الجاوة. قال في تقويم البلدان: وهي جزيرةٌ كبيرة مشهورة بكثرة العقاقير، قال: وطرف هذه الجزيرة الغربي حيث الطول مائةٌ وخمسٌ وأربعون درجة والعرض خمس درج. قال: وفي جنوبي الجاوة مدينة فنصور، التي ينسب إليها الكافور الفنصوري، وهي حيث الطول مائة وخمسٌ وأربعون درجة، والعرض درجةٌ واحدة ونصف.ومنها جزيرة الصنف. التي ينسب إليها العود الصنفي. وهي من أشهر الجزائر الموجودة في الكتب، وطولها من الغرب إلى الشرق نحو مائتي ميل، وعرضها أقل من ذلك، ومدينتها حيث الطول اثنتان وستون درجة.ومنها جزيرة قمار التي ينسب إليها العود القماري وهو دون الصنفي ومدينتها قمار حيث الطول ستٌ وستون درجة، والعرض درجتان، وشرقيها جزائر الصين.ومنها جزيرة الرامي، قال ابن خرداذبه: وبها الكركدن وجواميس لا أذناب لها، وبها البقم، وفيها ناس عراة في غياض لا يفهم ما يقولون، كلامهم صفير، يستوحشون من الناس، طول كل إنسان منهم أربعة أشبار، للرجل منهم ذكر صغير، وللمرأة فرج صغير، وشعر رؤوسهم زغبٌ أحمر، يتسلقون على الأشجار بأيديهم. وفي البحر هناك ناسٌ بيض، يلحقون المراكب سباحةً والمراكب في شدة جريها، يبيعون العنبر بالحديد يحملونه في أفواههم، وجزيرة فيها ناس سود يأكلون الناس أحياءً، وجبلٌ طينه فضة تظهر بالنار.الجملة الثانية في حيوانها:قد ذكر في مسالك الأبصار عن الشيخ مبارك الأنباتي: أن بها الخيل على نوعين: عرابٍ وبراذين وأكثرها ما لا يحمد فعله، قال: ولذلك تجلب الخيل إلى الهند من جميع ما جاوره من بلاد الترك، وتقاد له العراب من البحرين وبلاد اليمن والعراق، وإن كان في داخل الهند خيلٌ عراب يتغالى في أثمانها ولكنها قليلة.قال: ومتى مكث الخيل بالهند انحلت. وعندهم البغال والحمير، ولكنها مذمومة الركوب عندهم، حتى لا يستحسن فقيهٌ ولا ذو علم ركوب بغلة.أما الحمار فإن ركوبه عندهم مذلة وعارٌ عظيم، وخاصتهم تحمل أثقالهم على الخيل، وعامتهم تحمل على البقر من فوق الأنف، وهي عندهم كثيرة، وبها الجمال قليلة لا تكون إلا للسلطان وأتباعه: من الخانات، والأمراء والوزراء، وأكابر الدولة، وبها من المواشي السائمة ما لا يحصى: من الجواميس والأبقار والأغنام والمعز، وبها من دواجن الطير والدجاج والحمام والأوز وهو أقل أنواعه، وإن الدجاج عندهم في قدر خلق الأوز.وبها من الوحوش الفيل، والكركدن، وقد تقدم ذكرهما في الكلام عن الوحوش فيما يحتاج الكاتب إلى وصفه من الحيوان في المقالة الأولى، وفي غير ذلك من الوحوش التي لا تعد.الجملة الثالثة في حبوبها وفواكهها ورياحينها وخضراواتها وغير ذلك:أما الحبوب فقد ذكر عن الشيخ مبارك الأنباتي أن بها الأرز على أحدٍ وعشرين نوعاً، وبها من سائر الحبوب الحنطة، والشعير، والحمص، والعدس، والماش، واللوبياء، والسمسم، أما الفول فلا يوجد عندهم.قال في مسالك الأبصار: ولعل عدمه من حيث إنهم قومٌ حكماءٌ، والفول عندهم مما يفسد جوهر العقل، ولذلك حرمت الصابئة أكله.وأما الفواكه ففيه التين والعنب، على قلة، والرمان الكثير: من الحلو والمز، والحامض إلى غير ذلك من الفواكه: كالموز، والخوخ، والتوت المسمى بالفرصاد وبها فواكه أخرى لا يعهد مثلها بمصر والشام كالعنباء، وغيرها، والسفرجل على قلة، والكمثرى، والتفاح، وهما أقل من القليل، ولكنهما والسفرجل تجلب إليه.وبها من الفواكه المستحسنة الرانج، وهو المسمى عندهم بالنارجيل والعامة تسميه جوز الهند، وبه البطيخ الأخضر والأصفر، والخيار والثقاء، والعجور، وبه من المحمضات الأترج، والليمون والليم، والنارنج أما الحمر وهو التمر الهندي فكثير بباديتها.وأما الخضروات فقصب السكر ببلادها كثيرٌ لغاية، ومنه نوعٌ أسود صلب المعجم، وهو أجوده للامتصاص لا الأعتصار ولا يوجد في غيرها، ويعمل من بقية أنواعه السكر الكثير: من النبات وغيره، ولكنه لا يجمد بل يكون كالسميذ الأبيض.وعندهم من الخضروات اللفت والجزر، والقرع، والباذنجان، والهليون، والزنجبيل، والسلق، والبصل، والفوم وهو الثوم، والشمار والصعتر.وأما الرياحين فيها الورد، واللينوفر، والبنفسج، والبان والخلاف، والعبهر والنرجس، والفاغية وهي التامر حناء.وأما غير ذلك فعندهم العسل أكثر من الكثير، والشيرج ومنه وقودهم والزيت يأيتهم مجلوباً.وأما الشمع فلا يوجد إلا في دور السلطان، ولا يسمح فيه لأحد، والحلوى على خمسة وستين نوعاً، والفقاع والأشربة، والأطعمة على ما لا يكاد يوجد في غير ما هنالك.وبه من أرباب الصنائع صناع السيوف، والقسي والرماح والزرد، وسائر أنواع السلاح، والصواغ، والزراكشة، وغيرهم من سائر أرباب الصنائع.وللسلطان بدلي دار طراز، فيها أربعة الأف قزاز، تعمل الأقمشة المنوعة للخلع والكساوى والأطلاقات، مع ما يحمل إليه من قماش الصين والعراق والأسكندرية.الجملة الرابعة في المعاملات:أما نقودهم، فقد ذكر الشيخ مبارك الأنباتي: أن لهم أربع دراهم يتعاملون بها.أحدها- الهشتكاني، وهو وزن الدرهم النقرة بمعاملة مصر، وجوازه جوازه، لا يكاد يتفاوت ما بينهما، والدرهم الهشتكاني المذكور عنه ثمان جتيلات كل جتيل أربعة أفلس، فيكون عنه اثنين وثلاثين فلساً.الثاني- الدرهم السلطاني. ويسمى وكاني، وهو ربع درهم من الدراهم المصرية وكل درهم من السلطانية عنه جتيلان، ولهذا الدرهم السلطاني نصفٌ يسمى جيتلٌ واحد.الثالث- الششتكاني. وهو نصف وربع درهمٍ هشتكاني، ويكون تقديره بالدراهم السلطانية ثلاثة دراهم.الرابع- الدرهم الدرازدهكاني، وجوازه بنصف وربع درهمٍ هشتكاني أيضاً، فيكون بمقدار الششتكاني، ثم كل ثمانية دراهمٍ هشتكانية تسمى تنكه.أما الذهب عندهم فبالمثقال، وكل ثلاثة مثاقيل تسمى تنكة، ويعبر عن تنكة الذهب بالتنكة الحمراء، وعن تنكة الفضة بالتنكة البيضاء، وكل مائة ألف تنكة من الذهب أو الفضة تسمى لكاً، إلا أنه يعبر عن لك بالذهب باللك الأحمر، وعن لك الفضة باللك الأبيض.وأما رطلهم فيسمى عندهم ستر، وزنته سبعون مثقالأ، فتكون زنته بالدراهم المصرية مائة درهم ودرهمين وثلثي درهم، وكل أربعين ستراً من واحد وجميع مبيعاتهم بالوزن أما الكيل فلا يعرف عندهم.الجملة الخامسة في الأسعار:قد ذكر في مسالك الأبصار أسعار الهند في زمانه نقلاً عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي وغيره فقال: إن الجارية الخدامة لا تتعدى قيمتها بمدينة دهلي ثمان تنكات، واللواتي يصلحن للخدمة والفراش خمس عشرة تنكة.وفي غير دهلي أرخص من ذلك حتى قال القاضي سراج الدين: إنه اشترى عبداً مراهقاً نقاعاً بأربعة دراهم.ثم قال: ومع هذا الرخص إن من الجواري الهنديات من تبلغ قيمتها عشرين ألف تنكة وأكثر لحسنهن ولطفهن.ونقل عن الشيخ مبارك الأنباتي وكان فيما قيل قبل الثلاثين والسبعمائة فقال: إن أوساط الأسعار حينئذٍ أن تكون الحنطة كل من بدرهم ونصف هشتكاني، والشعير كل من بدرهم واحدٍ هشتكاني، والأرز كل من بدرهم ونصف وربع هشتكاني، إلا أنواعاً معروفة من الأرز فإنها أغلى من ذلك، والحمص كل منين بدرهم هشتكاني، ولحم البقر والمعز كل أبعة أستارٍ بدرهم سلطاني، والأوز كل طائرٍ بدرهمين هشتكانية، والدجاج كل أربعة أطيارٍ بدرهم هشتكاني، والسكر كل خمسة أستارٍ بدرهم هشتكاني، والرأس الغنم الجيدة السمينة بتنكة وهي ثمانية دراهمٍ هشتكانية والبقرة الجيدة بتنكتين وهما ستة عشر درهماً هشتكانية وربما كانت بأقل، والجاموس كذلك.أما الحمام والعصفور وأنواع الطير فبأقل ثمن، وأنواع الصيد من الوحش والطير كثيرةٌ، وأكثر مأكلهم لحم البقر والمعز مع كثرة الضأن عندهم إلا أنهم اعتادوا أكل ذلك.وقد حكى في مسالك الأبصار عن الخجندي أنه قال: أكلت أنا وثلاثة نفر رفاق في بعض بلاد دلي لحماً وخبزاً بقرياً وخبزاً وسمناً حتى شبعنا بجتيل: وهو أربعة أفلس كما تقدم.الجملة السادسة في الطريق الموصلة إلى مملكتي السند والهند:الطريق إلى مملكتي السند والهند:اعلم أن لهذه المملكة عدة طرقٍ: الطريق الأول: طريق البحر، قد تقدم في الكلام على الطريق الموصلة إلى اليمن ذكر الطريق من سواحل مصر: من السويس، والطور، والقصير، وعيذاب إلى عدن من اليمن في هذا البحر، ومن عدن إلى أن يركب في بحر الهند المتصل ببحر القلزم، إلى سواحل السند والهند، ويخرج إلى أي البلاد أراد من الفرض الموصلة اليها.الطريق الثاني- طريق بحر فارس، قد تقدم في الكلام على مملكة إيران ذكر الطريق الموصلة من حلب بغداد، ثم من بغداد إلى البصرة.قال ابن خرداذبه: ثم من البصرة إلى عبادان اثنا عشر فرسخاً، ثم إلى الخشبات فرسخان، ومنها يركب في بحر فارس: فمن أراد طريق البر إلى السند والهند، جاز هذا البحر إلى هرمز: مدينة كرمان، ومنها يتوصل إلى السند ثم إلى الهند ثم الصين.ومن أراد الطريق في البحر، فقد ذكر ابن خرداذبه: أن من أبلة البصرة في نهر الأبلة إلى جزيرة خارك في نخيل فارس سبعين فرسخاً، ومنها إلى جزيرة لابن ثمانين فرسخاً، ثم إلى جزيرة أبرون سبعة فراسخ، ثم إلى جزيرة خين سبعة فراسخ، ثم إلى جزيرة كيش سبعة فراسخ، ثم إلى جزيرة أبركاوان ثمانية عشر فرسخاً، ثم إلى جزيرة أرموز سبعة فراسخ، ثم إلى بار سبعة أيام، وهي الحد بين فارس والسند، ثم إلى الديبل ثمانية أيام، ثم إلى مصب مهران في البحر فرسخان، ثم من مهران إلى بكين أول أرض الهند أربعة أيام، ثم إلى المند فرسخان، ثم إلى كول فرسخان، ثم إلى سندان ثمانية عشر فرسخاً، ثم إلى ملي خمسة أيام، ثم إلى بلين يومان.ثم يفترق الطريق في البحر: فمن أخذ على الساحل- فمن بلين إلى باس يومان، ثم إلى السنجلي وكبشكان يومان، ثم إلى كودا مصب نهر فريد ثلاثة فراسخ، ثم إلى كيلكان يومان، ثم منها إلى سمندر، ومن سمندر إلى أورسير اثنا عشر فرسخاً، ثم إلى أبينه أربعة أيام، ثم إلى سرنديب يومان.ومن أراد جهة الصين عدل من بلين وجعل سرنديب عن يساره.فمن جزيرة سرنديب إلى جزيرة لنكبالوس عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً، ثم إلى جزيرة كله ستة أيام.وعن يسارها جزيرة بالوس على يومين، ثم على خمسة عشر يوماً بلاد تنبت العطر.الجملة السابعة في ذكر ملوك الهند:أما قبل الإسلام فملكها جماعةٌ منهم ملوك الكفر، أسماؤهم أعجمية لا حاجة إلى ذكرهم، فأضربنا عنهم.وأما في الإسلام فأول من أخذ في فتح ما فتح من الهند بنو سبكتكين: ملوك غزنة، المتقدم ذكرهم في مملكة خوارزم والقبجاق وما مع ذلك.ففتح يمين الدولة محمود بن سبكتكين منه مدينة بهاطية، وهي مدينة حصينة عالية السور وراء الملتان، في سنة ست وتسعين وثلثمائة وسار إلى بيدا ملك الهند، فهرب منه إلى مدينته المعروفة بكاليجار، فحاصره فيها حتى صالحه على مال، فأخذ المال وألبسه خلعته، واستعفى من شد وسطه بالمنطقة فلم يعفه من ذلك فشدها على كره: ثم فتح إبراهيم بن مسعود منهم حصوناً منه في سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.ثم كانت دولة الغورية بغزنة أيضاً.ففتح شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام بن الحسين الغوري منه مدينة لهاور في سنة سبع وأربعين وخمسمائة، أتبعها بفتح الكثير من بلادهم، وبلغ من الكناية في ملوكهم ما لم يبلغه أحدٌ من ملوك الإسلام قبله، وتمكن من بلاد الهند، وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة دهلي التي هي قاعدة الهند، وبعث أيبك المذكور عساكره، فملكت من الهند أماكن ما دخلها مسلمٌ قبله حتى قاربت جهة الصين.ثم فتح شهاب الدين محمد المذكور أيضاً بعد ذلك نهرواله في سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وتوالت ملوك المسلمين وفتوحاتهم في الهند إلى أن كان محمد بن طغلقشاه في زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الديار المصرية، فقوي سلطانه بالهند، وكثرت عساكره، وأخذ في الفتوح حتى فتح معظم الهند.قال في مسالك الأبصار قال الشيخ مبارك الأنباتي: وأول ما فتح منه مملكة تلنك؛ وهي واسعة البلاد، كثيرة القرى، عدة قراها تسعمائة ألف قرية وتسعمائة قرية.ثم فتح بلاد جاجنكز، وبها سبعون مدينة جليلة كلها على البحر، دخلها من الجوهر والقماش المنوع، والطيب، والأفاويه؛ ثم فتح بلاد لكنوتي، وهي كرسي تسعة ملوك.ثم فتح بلاد دكير، ولها أربعٌ وثمانون قلعة جليلات المقدار.ونقل عن الشيخ برهان الدين أبي بكر بن الخلال البزي: أن بها ألف ألف قرية ومائتي ألف قرية.ثم فتح بلاد دور سمند، وكان بها السلطان بلاك الدبو وخمسة ملوك كفار. ثم فتح بلاد المعبر: وهو إقليم جليلٌ له تسعون مدينة بنادر على البحر، يجبى من دخلها الطيب، والأنس، والقماش المنوع، ولطائف الأفاق.وذكر أنه حصل له من الأموال بسبب الفتوح التي فتحها ما لا يكاد السامع يصدقه. فحكى عن الشيخ برهان الدين أبي بكر بن الخلال المقدم ذكره: أنه حاصر ملكاً على حد بلاد الدواكير، فسأله أن يكف عنه على أن يرسل إليه من الدواب ما يختار ليحمله له مالأ، فسأله عن قدر ما عنده من المال فأجابه فقال: إنه كان قبلي سبعة ملوك: جمع كل واحد منهم سبعين ألف صهريج متسعةً من المال، فأجابه إلى ذلك، وختم على تلك الصهاريج باسمه وتركها بحالها، وأقر الملك باسم ذلك الملك، وأمر بإقامته عنده، وجعل له نائباً بتلك المملكة.وحكى عن علي بن منصور العقيلي من عرب البحرين أنه تواتر عندهم من الأخبار أن هذا السلطان فتح مدينة بها بحيرة ماء، وفي وسطها بيت بر معظم عندهم يقصدونه بالنذر، وكلما أتي له بنذر رمي في تلك البحيرة، فصرف الماء عنها وأخذ ما كان بها من الذهب، فكان وسق مائتي فيل والأفٍ من البقر، إلى غير ذلك مما يكاد العقل أن ينكره ولذلك حصل عنده من الأموال مالأ يأخذه الحصر، واتسعت أموال عسكره حتى جاوزت الوصف، حتى حكى الشيخ تاج الدين بن أبي المجاهد السمرقندي: أنه غضب على بعض خاناته لشربه الخمر فأمسكه وأخذ ماله، فكان جملة ما وجد له من الذهب ألف مثقال وسبعةً وثلاثين ألف مثقال، ومقدار ذلك ثلاثة وأربعون قنطار وسبعون قنطاراً، ومع ذلك يعطي العطاء الجزيل ويصل بالأموال الجمة.فقد حكى ابن الحكيم الطياري: أن شخصاً قد له كتباً، فحثى له حثيةً من جوهرٍ كان بين يديه، قيمتها عشرون ألف مثقالٍ من الذهب.وحكى الشريف السمرقندي: أن شخصاً قدم له اثنتين وعشرين حبةً من البطيخ الأصفر، حملها إليه من بخارى، فأمر له بثلاثة الأف مثقالً من الذهب.وحكى الشيخ أبو بكر بن أبي الحسن الملتاني أنه استفاض عنه أنه التزم أنه لا ينطق في إطلاقاته بأقل من ثلاثة الأف مثقال، إلى غير ذلك من العطاء الذي يخرق العقول.وحكى عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي: أنه مع كثرة البذل وسعة العطاء في هباته وما ينفقه في جيوشه وعساكره لا ينفق نصف دخل بلاده.قلت: ثم بعد محمد شاه ولي هذه المملكة من أقاربه سلطان اسمه فيروزشاه وبقي في الملك نحو أربعين سنة.ثم تنقلت المملكة في بيوتهم إلى أن كان من تمرلنك ما كان من فتح دلي ونهبها.ثم آل الأمر بعده إلى سلطان من بيت الملك، اسمه محمود خان وهو القائم بها إلى الآن. وقد صارت الدواكير منها لسلطان بمفرده، واسمه اليوم السلطان، غياث الدين.الجملة الثامنة في عساكر هذه المملكة وأرباب وظائفها:على ما ذكره في مسالك الأبصار عن دولة السلطان محمد بن طغلقشاه المقدم ذكره، نقلاً عن الشيخ مبارك الأنباتي وغيره.أما عساكره، فقد ذكر أنها تشتمل على تسعمائة ألف فارس: منهم من هو بحضرته، ومنهم من هو في سائر البلاد، يجري عليهم كلهم ديوانه، وأن عسكره مجتمع من الترك والخطا والفرس والهنود وغيرهم من الأجناس.وكلهم بالخيل المسمومة، والسلاح الفائق، والتجمل الظاهر، وأن أعلى عسكره الخانات، ثم الملوك، ثم الأمراء، ثم الأصفهسلارية، ثم الجند.وذكر أن في خدمته ثمانين خاناً أو أكثر، وأن لكل واحدٍ منهم من الأتباع ما يناسبه: للخان عشرة الأف فارس، وللملك ألف فارس، وللأمير مائة فارس، وللاصفهسلارية دون ذلك.وأن الأصفهسلارية لا يؤهل أحدٌ منهم للقرب من السلطان، وإنما يكون منهم الولاة ومن يجري مجراهم، وأن له عشرة الأف مملوكٍ أتراك، وعشرة الأف خادم خصي، وألف خزندار، وألف بشمقدار، وله مائتا ألف عبدٍ ركابية، تلبس السلاح وتمشي في ركابه، وتقاتل رجالةً بين يديه، وأن جميع الجند تختص بالسلطان، ويجري عليهم ديوانه حتى من في خدمة الخانات والملوك والأمراء، لا يجري عليهم إقطاعً من جهة من هم في خدمته كما في مصر والشام.وأما أرباب الوظائف من أرباب السيوف، فله نائبٌ كبير، يسمى بلغتهم امريت وأربعة نوابٍ دونه، يسمى كل واحدٍ منهم شق، وله الحجاب ومن يجري مجراهم من سائر أرباب الوظائف.وأما من أرباب الأقلام. فله وزيرٌ عظيم، وله أربعة كتاب سر، يسمى كل واحدٍ منهم بلغتهم دبيران، ولكل منهم تقدير ثلثمائة كاتب.وأما القضاة فله قاضي قضاةٍ عظيم الشأن، وله محتسب وشيخ شيوخ، وله ألف طبيب ومائتا طبيب.وأما غير هؤلاء فله ألف بازدار، تحمل الطيور الجوارح للصيد راكبةً الخيل، وثلاثة الأف سواق لتحصيل الصيد، وخمسملئة نديم، والفان ومائتان من الملاهي غير مماليكه الملاهي، وهي ألف مملوك برسم تعليم الغناء خاصةً، وألف شاعر بالعربية، والفارسية، والهندية، من ذوي الذوق اللطيف، يجري على جميع أولئك ديوانه مع طهارة الذيل والعفة في الظاهر والباطن.الجملة التاسعة في زي أهل هذه المملكة:أما أرباب السيوف فنقل عن الشيخ مبارك الأنباتي: أن لبس السلطان والخانات والملوك، وسائر أرباب السيوف نتريات، وتكلاوات، وأقبية إسلامية، مخصرة الأوساط خوارزمية، وعمائم صغار لا تتعدى العمامة منها خمسة أذرعٍ أو ستةً، وأن لبسهم من البياض والجوخ.وحكي عن الشريف نصر الدين محمد الحسيني الأدمي أن غالب لبسهم نتريةٌ مزركشةٌ بالذهب، ومنهم من يلبس مطرز الكمين بزركشٍ، ومنهم من يعمل الطراز بين كتفيه مثل المغل، وأقباعهم مربعة الأنبساط، مرصعة بالجواهر، وغالب ترصيعهم بالياقوت والماس، ويضفرون شعورهم ذوائب كما كان يفعل بمصر والشام في أول الدولة التركية، إلا أنهم يجعلون في الذوائب شراريب من حرير، ويشدون في أوساطهم المناطق من الذهب والفضة، ويلبسون الأخفاف والمهاميز، ولا يشدون السيوف في أوساطهم إلا في السفر خاصة.وأما الوزراء والكتاب، فزيهم مثل زي الجند، إلا أنهم لا يشدون المناطق: وربما أرخى بعضهم العذبة الصغيرة من قدامه كما تفعل الصوفية.وأما القضاة والعلماء، فلبسهم فرجيات شبيهاتٌ بالحندات ودراريع.وحكي عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي أنه لا يلبس عندهم ثياب الكتان المجلوبة من الروس والأسكندرية إلا من ألبسه له السلطان، وإنما لباسهم من القطن الرفيع الذي يفوق البغدادي حسناً، وأنه لا يركب بالسروج الملبسة والمحلاة بالذهب إلا من أنعم عليه بها السلطان.الجملة العاشرة في أرزاق أهل دولة السلطان بهذه المملكة:أما الجند، فنقل عن الشيخ مبارك الأنباتي أنه لا يكون للخانات والملوك والأمراء والأصفهسلارية بلادٌ مقررةٌ عليهم من الديوان إقطاعاً لهم.وذكر أن إقطاع النائب الكبير المسمى بأمريت يكون إقليماً عظيماً كالعراق.ولكل خان لكان، كل لك مائة ألف تنكة، كل تنكة ثمانية دراهم؛ ولكل ملك من ستين ألف تنكة إلى خمسين ألف تنكة؛ ولكل أمير من أربعين ألف تنكة إلى ثلاثين ألف تنكة، وللاصفهسلارية من عشرين ألف تنكةٍ إلى ما حولها، ولكل جندي من عشرة الأف تنكة إلى ألف تنكة، ولكل مملوكٍ من المماليك السلطانية من خمسة الأف تنكة إلى ألف تنكة، مع الطعام والكسوة وعليق الخيل لجميعهم على السلطان، ولكل عبدٍ من العبيد السلطانية في كل شهر عشر تنكات بيضاء، ومنان من الحنطة والأرز، وفي كل يوم ثلاثة أستارٍ من اللحم، وفي كل سنة أربع كساوٍ.وأما أرباب الأقلام، فإن الوزير يكون له اقليم عظيم نحو العراق إقطاعاً له، ولكل واحد من كتاب السر الأربعة مدينة من المدن النبادر العظيمة الدخل، ولأكابر كتابهم قرى وضياعٌ.ومنهم من يكون له خمسون قريةً. ولكل من الكتاب الصغار عشرة الأف تنكة. ولقاضي القضاة المعبر عنه بصدر جهان عشر قرىً، يكون متحصلها نحو ستين ألف تنكة، ولشيخ الشيوخ مثله، وللمحتسب قريةٌ يكون متحصلها نحو ثمانية الأف تنكة.وأما غير هؤلاء من سائر أرباب الوظائف، فذكر أنه يكون لبعض الندماء قريتان ولبعضهم قريةٌ، ولكل واحدٍ منهم من أربعين تنكة إلى ثلاثين ألف تنكة إلى عشرين ألف تنكة على مقادير مراتبهم، مع الكساوى والخلع والأفتقادات، وليقس على ذلك.الجملة الحادية عشرة في ترتيب أحوال هذه المملكة:وتختلف الحال في ذلك باختلاف أحوال السلطان أما الخدمة، فخدمتان: إحداهما الخدمة اليومية، فإنه في كل يوم يمد الخوان في قصر السلطان: ويأكل منه عشرون ألف نفر من الخانات، والملوك، والأمراء، والأصفهسلارية، وأعيان الجند، ويمد للسلطان خوانٌ خاص، ويحضره معه من الفقهاء مائتا فقيه في الغداء والعشاء ليأكلوا معه ويبحثوا بين يديه.وحكي عن الشيخ أبي بكر بن الخلال: أنه سأل طباخ هذا السلطان عن ذبيحته في كل يوم- فقال: ألفان وخمسمائة رأس من البقر، وألفا رأس من الغنم، غير الخيل المسمنة وأنواع الطير.والثانية- الجمعية، فحكي عن الشيخ محمد الخجنددي أن لهذا السلطان يوم الثلاثاء جلوساً عاماً في ساحة عظيمة متسعةٍ إلى غايةٍ، يضرب له فيها حير كبيرٌ سلطاني، يجلس في صدره على تخت عالٍ مصفح بالذهب، وتقف أرباب الدولة حوله يميناً وشمالأ، وخلفه السلاح دارية وأرباب الوظائف قيامٌ بين يديه على منازلهم، ولا يجلس إلا الخانات وصدر جهان وهو قاضي القضاة والدبيران وهو كاتب السر الذي يكون له النوبة ويقف الحجاب أمامه، وينادى مناداة عامة: إن من كان له شكوى أو حاجة فليحضر، فيحضر من له شكوى أو حاجةً، فيقف بين يديه فلا يمنع حتى ينهى حاله، ويأمر السلطان فيه أمره.ومن عادته أن لا يدخل عليه أحدٌ ومعه سلاح البتة حتى ولا سكين صغيرةٌ ويكون جلوسه داخل سبعة أبواب، ينزل الداخلون عليه على الباب الأول، وربما أذن لبعضهم بالركوب إلى الباب السادس.وعلى الباب الأول منها رجلٌ معه بوق، فإذا جاء أحدٌ من الخانات أو الملوك أو أكابر الأمراء، نفخ في البوق إعلاماً للسلطان أنه قد جاءه رجل كبير: ليكون دائماً على يقظة من أمره.ولا يزال ينفخ في البوق حتى يقارب الداخل الباب السابع، فيجلس كل من دخل عند ذلك الباب حتى يجتمع الكل، فإذا تكاملوا أذن لهم في الدخول، فإذا دخلوا جلس من له أهلية الجلوس ووقف الباقون، وجلس القضاة والوزير وكاتب السر في مكان لا يقع فيه نظر السلطان عليهم، ومد الخوان.ثم يقدم الحجاب قصص أرباب المظالم وغيرهم، وكل قوم حاجبٌ يأخذ قصصهم، ثم يرفعون جميع القصص إلى حاجب مقدمٍ على الكل، فيعرضها على السلطان، ويسمع ما يأمر فيها. فإذا قام السلطان جلس ذلك الحاجب إلىكاتب السر فأدى إليه الرسائل في ذلك فينفذها.ثم يقوم السلطان من مجلسه ذلك ويدخل إلى مجلس خاص، ويدخل عليه العلماء فيجالسهم ويحادثهم ويأكل معهم، ثم ينصرفون، ويدخل السلطان إلى دوره.أما حاله في الركوب، فإنه كان في قصوره يركب وعلى رأسه الجتر والسلاح دارية وراءه محمولاً بأيديهم السلاح.وحوله قريب اثني عشر ألف مملوكٍ، جميعهم ليس فيهم راكبٌ إلا حامل الجتر والسلاح دارية والجمدارية حملة القماش إذا كان في غير قصوره.وعلى رأسه أعلام سودٌ في أوساطها تنينٌ عظيم من الذهب، ولا يحمل أحدٌ أعلاماً سوداً إلا له خاصة.وفي ميسرته أعلامٌ حمرٌ، فيها تنينان ذهب أيضاً. وطبوله الذي يدق بها في الأقامة والسفر على مثل الإسكندر.وهو مائتا حمل نقارات، وأربعون حملاً من الكوسات الكبار، وعشرون بوقاً، وعشرة صنوج.قال الشيخ مبارك الأنباتي: ويحمل على رأسه الجتر إن كان في غير الحرب، فإن كان في الحرب حمل على رأسه سبعة جتورة، منها اثنان مرصعان لا يقومان لنفاستهما.قال: ولدسته من الفخامة والعظمة والقوانين الشاهنشاهية ما لا يكون مثله إلا الإسكندر ذي القرنين أو لملك شاه بن ألب أرسلان.ثم إن كان في الصيد فإنه يخرج في خف من اللباس في نحو مائة ألف فارس، ومائتي قيل، ويحمل معه أربعة قصور على ثمانمائة جمل، كل قصر على مائتي جملٍ ملبسةٍ جميعها بستور الحرير المذهبة، وكل قصر طبقتان غير الخيم والخركاوات.فإن كان ينتقل من مكان إلى مكان للتنزه وما في معناه، فيكون معه نحو ثلاثين ألف فارس، وألف جنيب مسرجة ملجمة، ما بين ملبس بالذهب ومطوق وفيها المرصع بالجواهر واليواقيت.وإن كان في الحرب، فإنه يركب وعلى رأسه سبعة جتورة، وترتيبه في الحرب على ما ذكره قاضي القضاة سراج الدين الهندي: أن يقف السلطان في القلب وحوله الأئمة والعلماء، والرماة قدامه وخلفه، وتمتد الميمنة والميسرة موصولةً بالجناحين، وأمامه الفيلة الملبسة البركصطوانات الحديد وعليها الأبراج المسترة فيها المقاتلة، وفي تلك الأبراج منافذ لرمي النشاب وقوارير النفط، وأمام الفيلة العبيد المشاة في خفٍّ من اللباس بالستور والسلاح، فيسحبون حبال الفيلة والخيل في الميمنة والميسرة، تضم أطراف الجيش من حول الفيلة ومن ورائها حتى لا يجد هاربٌ له مفراً.أما غير السلطان من عساكره، فقد جرت عادتهم أن الخانات والملوك والأمراء لا يركب أحدٌ منهم في السفر والحضر إلا بالأعلام، وأكثر ما يحمل الخان معه سبعة أعلامٍ، وأقل ما يحمل الأمير ثلاثةٌ، وأكثر ما يجر الخان في الحضر عشر جنائب، وأكثر ما يجر الأمير في الحضر جنيبان، وفي السفر يتعاطى كل أحد منهم قدر طاقته.وأما اتصال الأخبار بالسلطان، فذكر قاضي القضاة سراج الدين الهندي: أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال: فأحوال الرعية له ناس يخالطون الرعية، ويطلعون على أخبارهم، فمن اطلع منهم على شيءٍ أنهاه إلى من فوقه، وينهيه الآخر إلى من فوقه حتى يتصل بالسلطان. وأحوال البلاد النائية لاتصال الأخبار منها من السرعة ما ليس في غيرها من الممالك، وذلك أن بين أمهات الأقاليم وبين قصر السلطان أماكن متقاربةً، مشبهة بمراكز البريد بمصر والشام إلا أن هذه الأماكن قريبة المدى بعضها من بعض، بين كل مكانين نحو أربع غلوات سهم أو دونها، في كل مكان عشرة سعاةٍ ممن له خفةٌ وقوة، ويحمل الكتب بينه وبين من يليه، ويعدو بأشد ما يمكنه إلى أن يوصله إلى الآخر ليعدو به كذلك إلى مقصده، فيصل الكتاب من المكان البعيد في أقرب وقتٍ. وفي كل مكانٍ من هذه الأمكنة مسجدٌ وسوقٌ وبركة ماء. وبين دلّي وقبة الإسلام اللتين هما قاعدتا المملكة طبولٌ مرتبة في أمكنة خاصة، حيثما كان في مدينة وفتح باب الأخرى أو أغلق يدق الطبل، فإذا سمعه ما يجاوره دق، فيعلم خبر فتح المدينة وفتح باب الأخرى وغلقه.
|